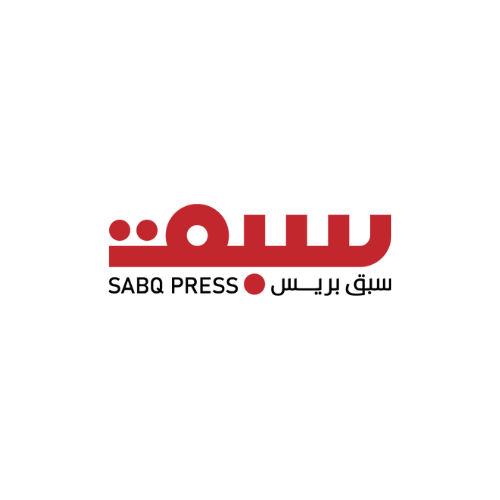أينما حلوا، حلَّ معهم الضجيج الأجوف، وأينما مروا، تركوا خلفهم أثراً من الفوضى والتباغض. إنها فئة "هجينة" تدعي الصحافة، لكنها في واقع الأمر لا تعدو كونها أبواقاً مسعورة لا تقتات إلا على افتعال الأزمات، وتتحرك في الملاعب والقاعات كأنها كائنات ضالة فقدت بوصلة المهنية، لتعوض عجزها التقني بالتهجم على أسياد الأرض والمنطق.
لم تكن مراكش بالأمس إلا محطة جديدة لإفراغ مكبوتات الفشل. هؤلاء الذين لا يملكون وطناً للروح الرياضية، يمارسون "البلطجة" في المناطق المختلطة، ويحولون المؤتمرات الصحفية إلى حلبات للصراخ العبثي. إن تاريخهم الأسود يلاحقهم كظلمة لا تنتهي:
من "غدر" أم درمان وتجييش النفوس ضد مصرالشقيقة،
إلى "العويل" في الكاميرون ومطاردة الحكام في المطارات كقطعان جائعة،
وصولاً إلى "التطاول" على أنغولا والكونغو بنظرات استعلائية مقيتة.
في مراكش، مدينة الكرم والشموخ، حاول هؤلاء "المفسدون" خرق بروتوكول الضيافة، والاعتداء على الجسم الصحفي المغربي بأسلوب لا يصدر إلا عن فئة تعودت على "التسكع" في دهاليز الكراهية. إنهم يذكروننا بتلك الكائنات التي تنبح كلما رأت قافلة النجاح المغربي تسير بخطى ثابتة، فيحاولون بضجيجهم تغطية صوت الإنجازات المغربية التي أبهرت العالم.
هذه "الشرذمة" التي تسيء للصحافة النزيهة، جعلت من الرياضة ساحة لتصفية حسابات ضيقة، فباتوا منبوذين في كل عاصمة إفريقية يزورونها. إنهم لا يبحثون عن الخبر، بل يبحثون عن "العظمة" المفقودة عبر شتم الآخرين واستهزاء بجمهور نيجيريا أو أنغولا، في سلوك يفتقر لأدنى قيم الإنسانية، ويجعلهم غرباء عن روح القارة السمراء التي تنبذ الحقد.
ستبقى مراكش شامخة، وسيبقى التنظيم المغربي عصياً على "الخربشات" الصبيانية. أما هؤلاء الذين اعتادوا العيش على الفتنة، فسيظلون "يدورون في حلقة مفرغة"، ينبحون خلف الأسوار بينما المجد يُكتب للأوفياء والمحترفين. إن التاريخ لا يسجل أسماء من يعضون اليد التي استضافتهم، بل يرميهم في مزبلة النسيان كذكرى سيئة لزمن رديء.