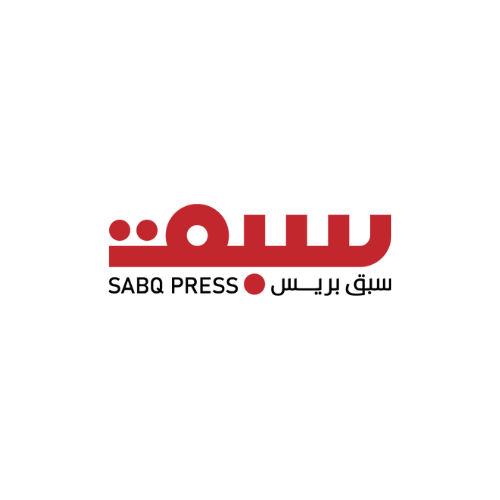مراكش، لم يقف المقهى يوماً عند حدود كونه مرتعاً لتبديد الوقت أو جلسةً لرشف الشاي المنعنع، بل كان خزانةً حية ولدت من رحمها نصوص غيرت وجه الثقافة المغربية. لكن اليوم، وبينما تتسابق الفضاءات في تقديم "الديكورات" الباذخة، يبرز سؤال جارح: أين اختفى المثقف المراكشي؟ وهل استسلم المقهى الأدبي لصالح "المقهى التجاري" الذي لا يقرأ ولا يكتب؟
لقد كانت المقاهي في مراكش بمثابة "جامعات شعبية" ومختبرات للأفكار. في تلك الفضاءات، نضجت تجارب جيل السبعينيات والثمانينيات، حيث لم يكن يهمنا بالضبط في أي ركن جلس هذا الأديب أو ذاك، بقدر ما كان يهمنا ذلك "المناخ العام" الذي يحول الطاولة إلى منصة للنقد، والجريدة إلى موضوع للسجال. كان المثقف المراكشي يعتبر المقهى امتداداً لبيته، وفضاءً لممارسة "المواطنة الثقافية" بعيداً عن الرسميات.
في قلب هذه الذاكرة، يبرز اسمان طبعاً هيبة "الكلمة" في مراكش. الأول هو محمد شهرمان (1948-2013)، "سلطان الزجل" وابن حي سيدي بن سليمان، الذي التقط لغة الشارع المراكشي وحولها إلى روائع مسرحية مثل "التكعكيعة" و*سوق الرشوق*. شهرمان لم يكن يكتب من أبراج عاجية، بل كانت نصوصه ابنة شرعية للملاحظة الدقيقة في المقاهي والدروب، قبل أن يرحل في صمت بعد سنوات من التهميش الجاحد.
أما القامة الثانية، فهو الأديب أحمد طليمات، الذي جعل من المقهى في كتاباته مرصداً سوسيولوجياً لرصد تحولات المدينة. طليمات، برصانته المعهودة، يمثل ذاكرة الرصيف المراكشي؛ ذاك الرصيف الذي كان يضج بنقاشات القصة والرواية قبل أن يكتسحه صخب "الاستهلاك السريع".
إن غياب هذه الوجوه الوازنة عن واجهة المقاهي اليوم، لا يعني انطفاء جذوة الإبداع، بل يعني أن "المقهى" فقد وظيفته كحاضنة فكرية. لقد تحول المقهى المراكشي من "صالون أدبي" ينتج المعرفة، إلى فضاء للاستهلاك السريع والهروب من الذات خلف شاشات الهواتف. المثقف اليوم يعيش "غربة" داخل فضاءات أصبحت تحتفي بالضجيج أكثر مما تحتفي بالصمت المنتج.
إن إحياء المقهى الأدبي في مراكش ليس ترفاً، بل هو ضرورة لاستعادة روح المدينة. نحن بحاجة إلى فضاءات تعيد الاعتبار لرموز من طينة شهرمان وطليمات، وتحترم هيبة القراءة. فمراكش التي ألهمت أجيالاً من المبدعين، تستحق أن تظل مقاهيها منارات للوعي، لا مجرد محطات انتظار في مدينة تسير بسرعة نحو نسيان ذاكرتها الإنسانية