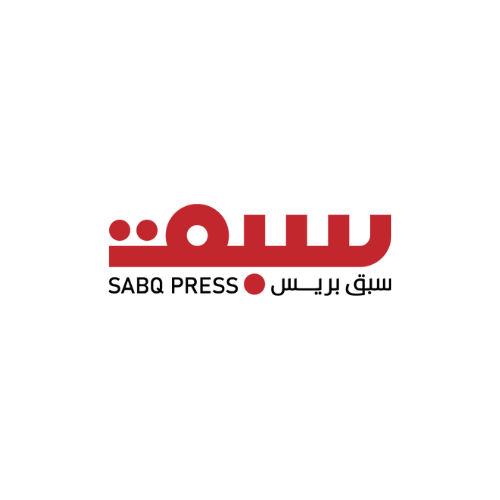بجملة واحدة، وبتوصيف لا يقبل التدرّج، جرى وضع الاحتجاج في إيران في خانة أخطر الجرائم الممكنة. المدعي العام محمد موحدي آزاد أعلن صراحة أن المشاركة في المظاهرات تُعد “عداءً لله”، وهي تهمة ينص القانون الإيراني على أن عقوبتها الإعدام، ما يعني عمليًا نقل الاحتجاج من فضاء السياسة إلى منطق العقوبات القصوى.
هذا التصريح، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لا يمكن قراءته كتحذير قانوني عابر، بل كرسالة ردع موجهة إلى المجتمع بأكمله. رسالة تختصر المسافة بين الشارع والمقصلة، وتغلق أي مجال لتأويل الاحتجاج باعتباره تعبيرًا عن غضب اجتماعي أو أزمة معيشية متفاقمة.

الخطاب نفسه يجد امتدادًا في مواقف سابقة صدرت عن أعلى هرم السلطة، حيث سبق لـ علي خامنئي أن قدّم الاحتجاجات باعتبارها تهديدًا وجوديًا، لا مجرد حراك داخلي. وبهذا، لم يعد المحتج مواطنًا ناقمًا أو مطالبًا بحقوقه، بل خطرًا يجب اجتثاثه، لا الاستماع إليه.
في هذا السياق، تُلغى الأسئلة الجوهرية تلقائيًا: لماذا تتكرر الاحتجاجات؟ لماذا يتسع الغضب الشعبي؟ ولماذا تفشل كل أدوات الاحتواء؟ فبدل البحث في الأسباب، يُكتفى برفع منسوب الاتهام، وتحويل الأزمة السياسية إلى ملف أمني مغلق، يُدار بلغة التحريم لا بلغة الحوار.
السخرية الجادة هنا أن التصعيد في الوصف لا يعكس قوة بقدر ما يكشف هشاشة. فحين تُستخدم أعلى التهم في مواجهة أبسط أشكال الاعتراض، يصبح واضحًا أن السلطة لم تعد تملك سوى التخويف أداةً وحيدة لضبط المجال العام.
في المحصلة، لا يبدو أن هذا الخطاب يسعى إلى إنهاء الاحتجاج بقدر ما يسعى إلى إخراجه نهائيًا من دائرة النقاش المشروع. وهو منطق قد يفرض الصمت مؤقتًا، لكنه يراكم الأسئلة المؤجلة، ويعمّق الفجوة بين السلطة والشارع، في انتظار لحظة لا تنفع معها لغة التحذير ولا سقوف الاتهام.